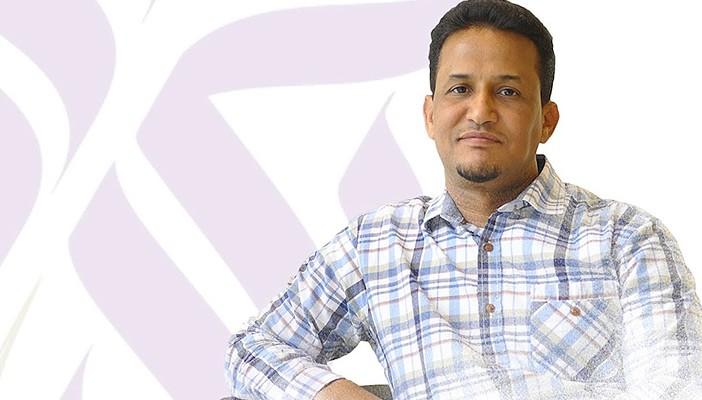ولو أقلع الأشراف (النبلاء) عن امتيازاتهم قبل ذلك ببضع سنين لاجتُنبت الثورة الفرنسية، ولكن ما العمل وقد وقع ذلك بعد أوانه؟ ولا يفيد ترك الحقوق كرهًا غير زيادة رغائب من تركت لأجلهم، فيجب في عالم السياسة كشف عواقب الأمور، ومنح المطالب طوعًا قبل أن يحل الوقت الذي تمنح فيه كرهًا”. (غوستاف لوبون، روح الثورات والثورة الفرنسية، ترجمة عادل زعيتر، ص 113).
ما أعظمها من حكمة فرنسية! وما أحوج حكام الدول العربية وقادة الجيوش العربية إلى استيعابها اليوم! لقد توصل غوستاف لوبون (1841-1931) عالم الاجتماع الفرنسي ورائد الدراسات المعاصرة لنفسية الجماهير إلى هذه الحكمة العميقة بعد تأمل طويل في تاريخ الثورة الفرنسية، غاص فيه على المزالق التي وقعت فيها فرنسا خلال قرن ونصف قرن من المواجهات الدامية.
وتألم ضمير الفيلسوف الفرنسي الكبير من المصائر التي صارت إليها الثورة الفرنسية، فتحدث عن “تلك الفاجعة العظمى” و”ذلك التاريخ المحزن” (ص 28)، التاريخ المضرج بدماء الفرنسيين التي انسكبت مدرارة على عتبات الاستبداد دون ضرورة.
“لم تبدأ الثورة الفرنسية راديكالية -على نحو ما توحي به الأحداث المثيرة التي اختزنتها الذاكرة الشعبية على مر القرون، بل كان المسعى الذي انتهجه الفرنسيون في بداية ثورتهم مسعى إصلاحيا محضا، وهو تحقيق ما توصل إليه جيرانهم الإنجليز قبل ذلك بقرن من الزمان من إقامة ملكية دستورية”.
وكان السبب الجوهري لكل ذلك “التاريخ المحزن” هو جهالة ملك فرنسا لويس الـ16، وتأخيره الإصلاح السياسي عن وقته، وعدم إدراكه عمق الموجة التاريخية التي بدأت في بلاده.
وربما تكون تجربة الثورة والثورة المضادة في فرنسا خلال الأعوام 1789-1794 من أثمن التجارب التي تحتاج أمتنا استخلاص العبرة والخبرة منها اليوم، وهذا ما نحاوله هنا بقدر ما تتسع له مساحة المقال.
ترجع أسباب الثورات إجمالًا إلى سبب عام هو تخلف الدولة عن المجتمع، وهو ما يؤدي إلى تآكل الشرعية السياسية للأنظمة الحاكمة في أذهان المحكومين، مع انفتاح تلك الأذهان على بدائل أفضل وأنبل.
فإذا كان الحكام ورجال البطانة المحيطون بهم يتسمون بالوعي التاريخي أدركوا مخاطر البركان الثوري الخامد قبل أن ينفجر، وتبنوا إصلاحات وقائية توجه طاقة البركان في اتجاه بناء مجتمعات أكثر عدلا ورحمة فجنبوا أنفسهم وشعوبهم دفع ثمن الثورات من الدماء والأموال.
وإذا اتسم الحكام وبطانتهم بالجهالة قرؤوا البركان الثوري قراءة سطحية، فاعتبروه سحابة صيف عابرة، وتلكؤوا في الإصلاح، بل ربما تمادوا إلى محاولة الوقوف في وجه البركان وصده بثورة مضادة لمطامح الشعوب، وهو ما ينتهي بانفجار البركان في وجوههم حمما مدمرة تحمل الخراب والدمار للحكام والمحكومين والدول والشعوب.
وقد كان تخلف الدولة عن المجتمع في فرنسا في النصف الثاني من القرن الـ18 يتجسد في استبداد وفساد الملك لويس الـ16، واحتكار طبقة النبلاء الإقطاعيين وطبقة الإكليروس (رجال الكنيسة) للمال والجاه مقابل تهميش عامة الشعب وممثليهم في البرلمان الذين أطلق عليهم ازدراء لقب “الطبقة الثالثة”.
وحينما نشبت الثورة الفرنسية عام 1789 -وهو المكافئ للعام 2011 من الزمن العربي الحاضر- لم يدرك ملك فرنسا ولا النبلاء ورجال الكنيسة عمق التحول التاريخي الذي تمر به فرنسا، سواء من حيث فاعلية الشرارة الفكرية التي فجرها فلاسفة السياسة الفرنسيون مونتسكيو، وفولتير، وروسو، أو البركان الاجتماعي المتفاعل في أحشاء المجتمع الفرنسي.
وربما يكون أكثر ما يتذكره الناس عن الثورة الفرنسية اليوم هو تلك الأحداث المهولة المعبرة عن راديكالية الثورة، مثل اقتحام سجن الباستيل، وقطع رأس الملك لويس الـ16، ثم قطع رأس زوجته الملكة ماري أنطوانيت، بيد أن هذه الأحداث لم تقع في يوم واحد، بل جاءت متباعدة زمنيا، وضمن سياق متدرج لا يفهم منطق الثورات ومآلاتها دونه.
فما بين سقوط الباستيل يوم 14 يوليو 1789 -أي بعد اندلاع الثورة بثلاثة أسابيع- وميتة السوء التي انتهى إليها الملك والملكة يومي 21 يناير 1793، و16 أكتوبر 1793 على التوالي درب طويل ومتعرج، انتقلت فيه الثورة الفرنسية من ثورة سياسية إصلاحية إلى حرب أهلية هوجاء.
لم تبدأ الثورة الفرنسية راديكالية -على نحو ما توحي به الأحداث المثيرة التي اختزنتها الذاكرة الشعبية على مر القرون- بل كان المسعى الذي انتهجه الفرنسيون في بداية ثورتهم مسعى إصلاحيا محضا، وهو تحقيق ما توصل إليه جيرانهم الإنجليز قبل ذلك بقرن من الزمان من إقامة ملكية دستورية تضمن للشعب حقه في حكم نفسه بحرية وعدل، وتحفظ للأسرة المالكة أمجادها التاريخية وكرامتها.
“لم يتحسر غوستاف لوبون على شيء أكثر من تحسره على الفرص الضائعة في تاريخ الثورة الفرنسية، فرص الانتقال المرن من الاستبداد إلى الحرية دون تدمير الأمة الفرنسية، وهي فرص ضيعتها الجهالة والأنانية السياسية وقصر النظر الذي اتسم به كل من الملك لويس وطبقة النبلاء ورجال الكنيسة”.
وحتى حينما نجح الثوار في الإمساك بزمام الأمور، وقرر البرلمان الفرنسي اعتبار نفسه مجلسًا تأسيسيًا، وبدأ بكتابة دستور جديد للبلاد صيغ هذا الدستور ليكون أساسا قانونيا لملكية دستورية في فرنسا، لا لإلغاء الملكية.
وقد عبر غوستاف لوبون عن ذلك في كتابه فقال: “لا شك في أن أكثرية الأمة الفرنسية كانت ملكية أيام المجلس التأسيسي الذي هو ملكي أيضا، وكان من المحتمل أن يظل الملك قابضا على زمام الحكم لو رضي بنظام ملكي دستوري، ولم يكن عليه إلا أن يأتي بعمل قليل ليتفاهم هو والمجلس” (ص 114) “ومن كان يجرؤ من رجال سنة 1789 على طلب قتل لويس الـ16؟” (ص 120).
وقد صبر الثوار الفرنسيون كثيرًا على جهالات الملك لويس وخياناته المتكررة وغدره بالثورة وتحالفه مع أعداء فرنسا “فلم يمقت الشعب الملك لطيشه واستغاثته بالأجنبي إلا بالتدريج، ولم يفكر المجلس الاشتراعي الأول (برلمان الثورة) في إقامة الجمهورية، وكل ما كان يحلم به هو أن تحل ملكية دستورية مكان الملكية المطلقة” (ص 93)، ولذلك لم يلغ الثوار الفرنسيون الملكية إلا يوم 21 سبتمبر/أيلول 1792 أي بعد ثلاثة أعوام من الملكية الدستورية.
فالثورة المضادة هي التي حولت الثورة الفرنسية من مطالب إصلاحية تخدم الحاكم والمحكوم إلى حرب وجودية لا تبقي ولا تذر، فقد قاوم الملك الإصلاحات الدستورية رغم تظاهره بالموافقة عليها، وخادع الثوار وهو يتظاهر بتلبية مطالبهم، ثم حاول الهرب من البلاد من أجل الاستظهار بالقوى الأجنبية ضد الثورة، كما قاوم النبلاء ورجال الكنيسة مبادئ “الحرية والمساواة والإخاء” التي اتخذتها الثورة شعارا لها، ولم يتنازلوا عن امتيازاتهم إلا بعد فوات الأوان كما لاحظ غوستاف لوبون.
ولم يتحسر غوستاف لوبون على شيء أكثر من تحسره على الفرص الضائعة في تاريخ الثورة الفرنسية، فرص الانتقال المرن من الاستبداد إلى الحرية دون تدمير الأمة الفرنسية، وهي فرص ضيعتها الجهالة والأنانية السياسية وقصر النظر الذي اتسم به كل من الملك لويس وطبقة النبلاء ورجال الكنيسة المستأثرين بالمال والجاه.
ثم توسعت ظاهرة الثورة المضادة الفرنسية، فالتحقت بها الملكيات الأوروبية التي أرعبتها شعارات الثورة الفرنسية، فتدخلت لصالح الملكية في فرنسا، وتشبه الثورة المضادة الفرنسية الثورة المضادة العربية التي نعيشها هذه الأيام بنية وأداء، فقد تشكلت الثورة المضادة للثورة الفرنسية من محاور، أهمها:
أولًا: متحزبون للنظام الملكي الفرنسي من داخل فرنسا، خصوصا من طبقة النبلاء ورجال الدين الكاثوليك، وهم المكافئون لبقايا الحزب الوطني في مصر، والتجمع الدستوري في تونس، والمؤتمر الشعبي العام في اليمن، وكتائب القذافي في ليبيا، وحزب البعث والقوى الطائفية المستترة بستاره في سوريا.
ثانيًا: منفيون من رجالات النظام القديم، أرغمتهم ظروف الثورة على الهرب من فرنسا فلجؤوا إلى الدول الأوروبية المجاورة، واتخذوها قاعدة انطلاق للثورة المضادة في بلدهم، واستظهروا بحكام تلك الدول في مسعاهم لوأد الثورة، وأمثال هؤلاء معروفون في عالم العرب اليوم، فالهاربون من وجه الثورات الذين لجؤوا إلى عواصم عربية معادية للثورات معروفون بالأسماء والعناوين.
ثالثًا: الملكيات الأوروبية التي أصابها الهلع من سقوط ملك فرنسا، ومن المضمون الكوني لمبادئ الثورة الفرنسية فانخرطت في عداوة مجانية للجمهورية الجديدة بدلًا من إصلاح أنظمتها السياسية واستيعاب شعوبها، والشبه بين تلك الملكيات الأوروبية وبعض الملكيات العربية التي تزعمت الثورة المضادة اليوم واضح للعيان، فقد أنفقت ملكيات عربية خزائن دولها لوأد ثورات العربي، وربما يكون أدق تعريف للثورة المضادة العربية هو أنها سفك الدماء العربية بالأموال العربية من أجل إبقاء الشعوب العربية في نير العبودية.
رابعًا: مجموعة من “رجال 1789” كما دعاهم الباحث الأميركي في الثورة المضادة الفرنسية سوثرلاند في كتابه “فرنسا 1789-1815.. الثورة والثورة المضادة”، وهو يقصد بهم ثوارا سابقين ارتدوا عن الثورة بدافع الأنانية السياسية، والانتصار للنفس على المبدأ بعدما لم يجدوا في الثورة ما توقعوه لأنفسهم من مناصب وأمجاد شخصية، وأمثال هؤلاء من أهل “الردة الثورية” معروفون، خصوصا في حالة مصر بعد انقلاب السيسي.
ومع أوجه الشبه بين الثورة المضادة الفرنسية والثورة المضادة العربية لا غرو أن يكون الحصاد في الحالتين مرا ومتشابها، لقدتحول الفعل الثوري الفرنسي -بسبب الثورة المضادة- من مسعى إصلاحي منطقي إلى غريزة انتقامية هوجاء، وهو ما حدث للربيع العربي اليوم مع استحكام همجية الحكام، وصعود السلفية الجهادية ردا على ذلك.
وكان من الثمار المريرة للثورة المضادة الفرنسية انتقال زمام الثورة من أيدي قادتها الإصلاحيين، من أمثال لا فاييت، ودانتون، ومونيي إلى قادتها الراديكاليين المتعصبين، من أمثال روبسبيير الذي كان يقول “إن الجمهورية لا تقوم إلا بإبادة مخالفيها” (ص 123)، وكاريه الذي كان “يكره ضحاياه على حفر قبورهم ليدفنهم فيها أحياء” (ص 139) كما يفعل تنظيم الدولة أحيانا في أيامنا هذه.
ووصل الأمر إلى “اعتداء زعماء الثورة الفرنسية على المباني والآثار الفنية التي عدوها بقايا ماض ممقوت” (ص 140)، وهو أمر يشبه أفاعيل تنظيم الدولة ببعض الآثار الدينية والتاريخية بناء على تصوراته الفقهية التي جمعت بين السذاجة والعنف، فالظواهر الاجتماعية تتشابه في كل زمان ومكان مهما اختلفت العقائد والأمزجة الثقافية.
على أن روبسبيير وكاريه ومن لف لفهما لم يولدوا راديكاليين، بل إن الثورة المضادة -بما اشتملت عليه من تواطئ الداخل والخارج على المثل والقيم الإنسانية التي دعوا إليها- هي التي جعلتهم كذلك.
وقد لاحظ غوستاف لوبون -وهو الخبير بنفسية الجماهير- الأثر السلبي الذي خلفته الثورة المضادة على نفسية الثوار الفرنسيين فكتب “إن كثيرا من رجال الإصلاح والقضاء -الذين كانوا موصوفين بالحلم- انقلبوا أيام الهول إلى أناس متعصبين سفاكين للدماء، حقا قد يصير المرء بتأثير البيئة الجديدة امرأ آخر” (ص 55)، وهذه ملاحظة ثمينة تفسر لنا كيف تحول الشباب العرب اليوم من الاحتجاجات السلمية إلى المفاصلة الجهادية.
“ليس من اللازم أن يكرر العرب محنة الفرنسيين، ولا أن يخوضوا تلك المسارات الدموية المرهقة التي خاضتها الثورة الفرنسية، فقد تعلمت أمم كثيرة من التجربة الفرنسية كيف تنتقل من الاستبداد إلى الحرية بثمن أرخص ووقت أخصر”
لقد عانى الحاكم والمحكوم من الثورة المضادة في التاريخ الفرنسي، ويمكن القول إنه لولا الثورة المضادة الفرنسية لكانت أسرة آل بوربون لا تزال تنعم بالتاج الفرنسي بكل ما يحيط به من المجد والثروة، كما هو حال الأسرة المالكة في بريطانيا اليوم، ولما كان مصير ملك فرنسا لويس الـ16 هو قطع رأسه بالمقصلة، وقطع رأس زوجته الشابة ماري أنطوانيت التي وصفها أدموند بورك في كتابه “تأملات في الثورة الفرنسية” الصادر عام 1790 -أي بعد عام من اندلاع الثورة- بأنها كانت “مثل نجمة الصبح مشرقة بالمجد والسعادة”، ولما كان الشعب الفرنسي دخل مسارا دمويا طويلا ومضنيا.
ليس من اللازم أن يكرر العرب محنة الفرنسيين، ولا أن يخوضوا تلك المسارات الدموية المرهقة التي خاضتها الثورة الفرنسية، فقد تعلمت أمم كثيرة من التجربة الفرنسية كيف تنتقل من الاستبداد إلى الحرية بثمن أرخص ووقت أخصر.
أما نحن فليس أمامنا إلا أن نردد على أسماع قادة الدول والجيوش العربية حكمة الفيلسوف الفرنسي غوستاف لوبون التي صدرنا بها هذا المقال “يجب في عالم السياسة كشف عواقب الأمور، ومنح المطالب طوعا قبل أن يحل الوقت الذي تمنح فيه كرها”، فلا يزال في وسع الرؤساء والملوك وقادة الجيوش في البلاد العربية أن يتعلموا من تاريخ الثورة الفرنسية ما يجب تجنبه في لحظة الثورات فيتوبوا توبة نصوحا من الثورة المضادة، ومن العداوة الخرقاء لآمال شعوبهم في بناء مجتمعات أكثر حرية وإنسانية.
وسيظل الأمل قائما في ظهور حكماء من قادة الدول العربية والجيوش العربية ينتقلون من منطق الثورة المضادة إلى منطق الإصلاح الوقائي، ويلتقون مع شعوبهم في منتصف الطريق كما فعل ملك المغرب محمد السادس، فيحموا دولهم من آلام الانتقال، ويجنبوا أنفسهم لعنة التاريخ.
أما الجهلاء منهم فلا أمل فيهم، إذ سيظلون يجهدون في رفع ثمن التغيير على شعوبهم، وفي تأجيل انتصار الثورات حتى تجرفهم رياح التاريخ العاتية غير مأسوف عليهم، فلا أحد يستطيع كبت أشواق الحرية التي تفجرت في البلاد العربية ختام العام 2010، والتاريخ لا يرحم من لا يتعلمون منه.