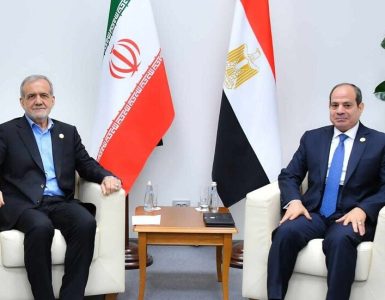تعاني أوطاننا العربية والإسلامية منذ حقبة الاستعمار، ومن بعده في ظل الدول القومية حديثة الاستقلال المشبعة بإرث هذا الاستعمار، تعاني المواجهة (encounter) بين نموذجين حملا مشروعين للتغيير المجتمعي والسياسي: المشروع الحداثي العلماني، والمشروع الإسلامي الحضاري، وفيما يتعلق بالسياسة بصفة خاصة (وإن كان لا يمكن فصلها عن غيرها من المجالات في المشروع الإسلامي، ومن هنا خطأ المصطلح الذائع "الإسلام السياسي").
تمحور المدخل العلماني للسياسة في رفض العلاقة بين الدين والدولة أو توظيف الدين في السياسة، وتعددت مبررات هذا المدخل ودوافعه في الدفاع عن "الدولة العلمانية" (أو كما يسمونها: المدنية) كأساس للديمقراطية وحقوق الإنسان والتقدم. أما المدخل الإسلامي فلقد استحضر الإسلام إلى السياسة بأكثر من مقترب، وانطلاقا من علاقته العضوية بالمجتمع والدولة وفقا لشريعة الإسلام الشاملة (عقيدة وأحكاما، وقيما، ومبادئ وأسسا)، وبعيدا بالطبع عما يسمى "الدولة الدينية" التي رفع العلمانيون فزاعتها، مستحضرين الخبرة الظلامية في أوروبا القرون الوسطى، ودون تمييز بين هذه الخبرة وبين خبرة الدولة الإسلامية في عصور النور والعدل والحضارة منذ بداية الرسالة المحمدية.
والقضية على هذا النحو ذات تفاصيل كثيرة، وشهدت منحنيات ومرتفعات متتالية ومتراكمة، حفلت كتب التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي عبر قرنين بشرح خرائطها وأبعادها وخاصة حول "الجدالات والحوارات الإسلامية العلمانية" وما ارتبط بها من جولات الصراع السياسي، وخاصة منذ بداية القرن العشرين حين ظهرت تنظيمات وحركات إسلامية -وعلى رأسها: حركة الإخوان المسلمين في مصر- حملت المشروع الإسلامي على كافة الأصعدة ومنها: الصعيد السياسي.
دشن هذا الظهور للحركة الإسلامية المنظمة، التمايز بين ثلاثة أنماط من "الإسلامية": ما أسميه "إسلامية المجتمع" و"إسلامية التنظيمات والحركات"، و"إسلامية الدولة". وتفرق النمط الأول بين النمطين الآخرين، واقترب منهما وانفصل عنهما، وقاد النمط الثاني نخب فكرية ومجتمعية متنوعة الخلفيات وإن اجتمعت على ضرورة عودة التحام الناس بالمرجعية الإسلامية للحياة، لقيادة الجهاد ضد الاستعمار والظلم والفقر والتخلف، وقاد النمط الثالث علماء الأزهر وذلك بعد أن تحول الأزهر تدريجيا إلى مؤسسة رسمية توفر، وخاصة بعد ثورة 1952، ظهيرا دينيا للمؤسسة المتحكمة (العسكرية العلمانية) التي سيطرت على كافة مفاصل الدولة والمجتمع وانفردت بالحكم ومارست التأثير على السياسة، واستمر هذا الوضع حتى بعد أن توارت هذه النخبة العسكرية للخلف قليلا في ظل الديمقراطية التسلطية التي اضطر إليها حكام مصر من العسكر تحت ضغوط المتغيرات الوطنية والعالمية.
وبقدر ما يحوي تاريخنا الحديث من لمحات مضيئة من جهاد الأزهر وحمايته للوطن والناس والشريعة ضد الاستعمار والظلم والفساد والاستبداد، بقدر ما أخذت تخفت هذه الأنوار وتقتصر على رموز فردية، وتحول الأزهر لمؤسسة رسمية تحافظ على "الوضع القائم" وتبرر سياساته. ومن ثم كان لابد، ولأسباب أخرى مذهبية وفكرية…الخ، أن تحدث المواجهة بين الأزهر -باعتباره معقل الوسطية وحارس العلوم الإسلامية- وبين التنظيمات والحركات الإسلامية بكافة روافدها، حتى أكثرها سلمية ووسطية مثل: جماعة الإخوان المسلمين، والتي ظلت طوال أكثر من ستين عاما حتى الآن في صراع مع "سلطة العسكر"، والتاريخ المعاصر والراهن يحفل بالتفاصيل.
وما يعنيني الآن بعد هذه المقدمة، التي فرضتها ذاكرة التدبر، مآل مقولة اللعب بالدين وتوظيفه في السياسة واستحضار "المقدس" إلى "النجس" كما يرددون. فهذه المقولة أضحت اليوم لقمة سائغة في أفواه العوام والنخب العلمانية على حد سواء. وتلك النخب تؤسس بها لفزاعة مسطحة ضد كل ممارس للسياسة بمرجعية إسلامية، وهي فزاعة لتعبئة العوام ضد "إسلامية الحركات" توظف كل نتائج الفصل القائم في نظم التعليم بين العلوم الإسلامية (حبيسة المعاهد الأزهرية) وبين العلوم "المدنية والحديثة"، والتي في ظلها انقطعت صلة الناس بالإسلام، ثقافة وتاريخًا، ولم يبقَ لهم إلا "العبادات" وبعض الأحكام الشخصية. وبذا تحول الإسلام إلى "دين علماني" في نطاق المساجد والحياة الخاصة، حتى لدى أكثر الناس تدينًا والتزامًا، واعتبر ماعدا ذلك لعبًا بالدين وتوظيفا له في السياسة وخروجًا على الحاكم.
والخطير في كل هذا الأمر أن شيوخًا وعلماء يتقاسمون هذا النهج مع النخب العلمانية؛ فيعتبر كل منهم "الحركات الإسلامية" خطرًا وتهديدًا، وإن لكل جانب من المشايخ والعلمانيين مبرراته ودوافعه، فقد اجتمعوا في النهاية ضد "عدو" واحد.
ومن ناحية أخرى، فإن الأكثر خطورة في هذا المشهد الراهن أمران تجسدا خلال العامين ونصف الماضيين، ويصلان الآن -مع الانقلاب العسكري- إلى تجليات فاضحة وكاشفة ومخزية في نفس الوقت.
الأمر الأول: وهو هرولة العلمانيين –بعد ثورة 25 يناير التي حررت حركة الإسلاميين ومشاركتهم في العملية الديمقراطية الوليدة- إلى "الأزهر" ليتحالفوا ضد صعود هذه الحركات الباهر منذ 25 يناير، والذي اعتبره الطرفان تهديدًا وخطرًا على "إسلامية المجتمع" بقيادة الأزهر أو لـ"علمانية الدولة" المبتغى تقنينها في الدستور وفي ممارسة السياسة في إطار "ديمقراطية بلا إسلاميين".
الأمر الثاني: أن العلمانيين من المفكرين أو الأدباء… وحتى الفنانين تولوا -بفجاجة وجرأة وعلى سمع وبصر الشيوخ والعلماء، بل وبتأييد ومباركة من بعضهم- تولوا شرح المقصود بـ"الإسلام الصحيح"، "إسلام مصر" في مواجهة الإسلام "الحركي" المشارك في اللعبة السياسية في إطار قواعد الديمقراطية بعد إعلان قبول آلياتها حكَمًا بين اللاعبين المتنافسين، من العلمانيين والإسلاميين على حد سواء. ولم يرَ هؤلاء العلمانيون –ومعهم الأزهر وشيوخه ومنهم د.علي جمعة- في هذه المشاركة إلا تهديدًا وخطرًا لابد من التصدي له بكافة الطرق والوسائل.
والأكثر خطورة من ناحية ثالثة في هذا التحالف "الأزهري-العلماني"، أن الظهير الديني للثورة المضادة لثورة 25 يناير قد انكشف مع الانقلاب العسكري، وأضحى –وبوضوح- ليس مجرد ظهير لولي الأمر من السلطة الانقلابية (دور شيخ الأزهر منذ 3/7) ولكن مبررًا لأفعاله الدموية في المجازر واقتحام المساجد وحصارها وحصار القرى واقتحامها… ومن ثم ظهيرًا دينيًا للموجة العلمانية الكاسحة والمكتسحة الآن سواء في تشكيل الحكومة أو لجنة الخمسين أو المؤسسات والهيئات الرسمية للدولة العميقة… وهي الموجة العلمانية الفكرية والسياسية المدعومة بإعلام تآمري تحريضي إقصائي استئصالي تموله جيوب "مباركية" من قوى الثورة المضادة ويتحالف معهم –للأسف- شركاء في ثورة 25 يناير.
ولذا لا عجب على الإطلاق الآن أن نجد أن مفردات خطاب جبهة الإنقاذ ومفردات النخب الانقلابية التي تتهم وتشيطن "الإخوان" بصفة خاصة بصورة "بذيئة ومبتذلة وعدوانية وعديمة التسامح وإقصائية لأقصى درجة"، إنما تتطابق مع مفردات استخدمها علي جمعة بوضوح وخاصة منذ اجتياح الاعتصامات، وظهرت هذه المفردات على التوالي في خطبتين للجمعة، وفي حديث مسجل للشئون المعنوية للقوات المسلحة، وفي حديثين تليفزيونيين مطولين، وأخيرًا في تعليقاته المكتوبة والمسموعة (عبر 3 فضائيات يوم 22/9/2013) حول واقعة تهجم الطلاب عليه بالقول في كلية دار العلوم.
هنا مربط الفرس الذي أبتغيه، وتمثل الكلمات عاليًا سياقًا له، وأتوقف عند مفردات علي جمعة تلك وسياقها لنعرف من الذي يلعب بالدين في السياسة؟ وكيف؟ ولماذا؟
فإن خطابات د.علي جمعة نضحت وأفصحت على التوالي بما يلي:
1- المعتصمون من الإخوان خوارج قتلهم شرعي بل مطلوب حفاظًا على وحدة الوطن.
2- أهل كرداسة من"الأوباش الفجرة" …الخ من مفردات خطبة يوم الجمعة 20/9 في مسجد آل رشدان.
3- الإشارة الدائمة بشهداء رجال الشرطة والجيش وعدم الإتيان على ذكر من سقط منذ 8/7 وحتى الآن: شهيدًا أو مصابًا أو معتقلا، ويقدرون بعشرات الآلاف.
4- عدم التحذير من مخاطر الصدع في المجتمع والوطن.
5- وصف الإخوان بالكذابين، الجهلة، غير محبي الوطن، الخارجين دائمًا على القانون والدولة.
6- وصف الشباب بعدم التربية وبأنهم "أولاد الشوارع".
ورغمًا عن الأطر والمفردات الشرعية التي أحاط بها علي جمعة هذه المضامين، شرحًا لها وتبريرًا من داخل الفقه والفكر والتاريخ الإسلامي، إلا أنها جاءت كما يراه ويدركه هو أو كما أراد أن يوظفه في هذه اللحظة، مما أثار ردود فعل رافضة من عديد من العلماء الذين تصادم معهم إلى درجة توجيهه السباب والإهانة لبعضهم.
إذن من الذي يوظف الدين هنا؟ بغض النظر عن نوايا صاحب الرأي وموقعه الآن، إلا أنه يستدعي الدين ليأخذ جانب طرف على طرف. إذن وهو الشيخ العلامة، والمفتي الأسبق والطامح دائمًا لمشيخة الأزهر، يخرج على الناس في وقت أزمة وتصدع في المجتمع وانقلاب عسكري على السلطة الشرعية، ليس بفتاوى وآراء مهنية فقط ولكن بآراء سياسية في طرف دون آخر، يحقر منه ويتهمه بأفظع صفات غير المؤمن. هو إذًا من وجهة نظري يلعب "سياسة"، بل هو "سياسي" بكل معنى الكلمة.
إن المفزع في هذه الخطابات الراهنة لد.علي جمعة ليس مضمونها فقط، ولكن أسلوبها الذي يخرج عن كل ما كنت اعرفه من قيم وسلوك د.علي جمعة (الذي درست وتعلمت معه لفترة ممتدة 1986 – 2002). فهي خالية من الرحمة والتسامح ومليئة بالغمز واللمز والكلمات النابية، والأهم أنها تصدر من فم فوقه عينان تنضحان بملامح وقسمات غريبة ومستهجنة أن تصدر من أي عالم تنضحان بـ: الشماتة والتحدي والتحقير… .
آسف للقول أن صوره المبثوثة من على منصة دار العلوم، وهو ينظر إلى طلبة صغار يحرقهم من فقدوه من أصدقاء وأخوة وأهل في اجتياح الاعتصامات والمظاهرات، تستدعي إلى ذاكرتي ما كنت أتصوره عن ملامح تاجر البندقية اليهودي وهو ينتظر تنفيذ الحكم في الشاب الذي اقترض منه ولم يستطع الوفاء بالديْن…
أعتذر لله تعالى عن قولي هذا في أحد أئمة وعلماء مصر الذي تعلمت على يده ومنه.. إلا أنه ليس د.علي جمعة الذي عرفته أو الذي اعتقدت أنني أعرفه.