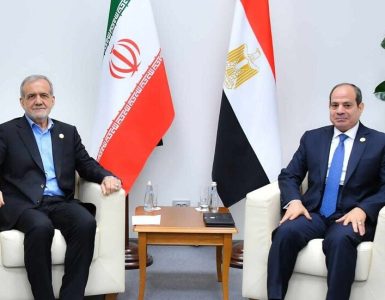“استقِل قبل أن تضيق عليك الأرض بما رحبت، ولا تُدخل نفسك في صراع سياسي أكبر منك؛ فساعتها ستزلّ قدمك دون مغيثٍ أو نصيرٍ”.
مُررت هذه الرسالة بتوقيع محمد الباز، رئيس تحرير يومية “الدستور” (المستقلة)، محذّرًا شيخ الأزهر بعد عتابٍ مبطّن من السيسي له في مؤتمرٍ علنيٍّ عُقد مؤخرًا بقوله: “تعبتني يا فضيلة الإمام”.
فماذا أصاب العلاقة بين النظام والأزهر بحيث انتقلت معه من طور التماهي إلى الشقاق؟ هل ثمة ابتزاز؟ أم معركة عض أصابع؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه خلافًا سائغًا بين متحَالفيْن؟
وبالأمس فقط استدعى عبدالفتاح السيسي شيخ الأزهر واستقبله بقصر الاتحادية، وبعد انتهاء اللقاء قالت الرئاسة المصرية في بيان لها إن “اللقاء شهد استعراضًا للجهود التي يقوم بها الأزهر الشريف لتجديد الخطاب الديني وتنقيته من الأفكار المغلوطة وتعزيز الحوار بين الأديان على الصعيد الدولي”.
وحث السيسي الطيبَ على “استمرار الجهود التي يقوم بها الأزهر في تجديد الخطاب الديني في الداخل والخارج، والتأكيد على قيم التقدم والتسامح وقبول الآخر؛ خاصة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الأمة، التي تواجه فيها تحدي الإرهاب المتنامي على نحو غير مسبوق”، وفق البيان.
فهل ارتأى السيسي ضرورة استدعاء شيخ الأزهر إلى القصر بهدف التفاهم أم أنها خطوة للتصالح وطيّ صفحة الخلاف التي ما فتئت تُفتح أمام الجميع؟
نظرة تاريخية
لم يكن الأزهر يومًا مجرد جامعٍ وجامعة، ولم يقتصر دوره على تدريس العلوم الدينية والدنيوية؛ بل كان له دورٌ سياسيٌّ بارزٌ تذبْذَبَ بين القوة والضعف، وظلت علاقة الأزهر بالسلطة تتراوح بين التماهي والتقارب حينًا، والمواجهة والصدام حينًا آخر.
ففي عهد الدولة العثمانية عاش الأزهر واحدًا من أزهى عصوره؛ حيث تعهّدت الدولة مبانيه بالإصلاح والترميم، وكذا الدارسين بالأدوات التي من شأنها إعانتهم على تحصيل العلم؛ بل واستحداث منصب شيخ الأزهر للمرة الأولى في تاريخه، حيث كان أول من تقلّد المنصب الشيخ “عبدالله الخراشي”، رغم آراء تاريخية تذهب إلى أن 15 شيخًا سبقوه إلى هذا المنصب، كل هذا فضلًا عن تراجع الصراع بين المذاهب الأربعة بشكل كبير، وتزايد إيرادات الأزهر وأوقافه خلال تلك الفترة، وتحمل الأزهر تبعات مسؤولياته في قيادة الأمة في مجابهة الحملة الفرنسية ومن بعدها الاحتلال الإنجليزي.
بعد قيام ثورة يوليو فقد الأزهر استقلاليته رويدًا رويدًا، وعمل الضباط الأحرار على الحد من استقلاليته، وتم وضع اليد على أوقاف الأزهر؛ ما أدّى به إلى التماهي مع توجه الدولة الاشتراكي وخط المعاداة لإسرائيل والغرب.
وساير الأزهر في عهد السادات -الذي كان حريصًا على أن يُصدّر نفسه باعتباره “الرئيس المؤمن”- نظام الحكم الجديد من حيث تأييد المصالحة مع الإخوان، وكذا التطبيع مع “إسرائيل“، إضافة إلى القضاء على الشيوعية وفلولها، وشهد عهد مبارك ذروة انبطاح الأزهر أمام رغبة الحاكم ومجاراة الأزهر للسلطة في كل مواقفها؛ ما حدا إلى فقدان الثقة في الأزهر من قطاع عريض من جموع الشعب المصري.
مكسبٌ لم يكن في الحسبان
فاجأت الثورة المصرية الأزهر كغيره من مؤسسات الدولة، ونظرًا لغياب “النظرة الاستشرافية الاستطلاعية” للأزهر باعتباره جزءًا من نظام بليد بطبعه -فضلًا عن كون الإمام الأكبر للأزهر عضوًا في الحزب الوطني المنحل ولجنة سياساته- لم يخرج الموقف الرسمي للأزهر عن سياق الموقف العام للدولة من حيث وصف الأحداث بكونها “أداةً لتفتيت مصر وتصفية حسابات وتنفيذ أجندات خارجية”؛ حيث دعا الأزهر الثوار إلى ترك الميدان والعودة إلى بيوتهم تاركين الأمر “للقيادة الرشيدة الحكيمة” ممثلةً في مبارك وقياداته الأمنية.
ورغم الموقف المشين للأزهر من الثورة المصرية، فإن أجواء الثورة المتسارعة دفعت الأزهر إلى الاضطلاع بدور مهم في الحياة السياسية المصرية والإفلات من سلطة الدولة استغلالًا لحالة الفراغ السياسي الذي خلفته ثورة يناير. ونتيجة لذلك؛ أصدر الأزهر وثيقة بخصوص ثورات الربيع العربي تحت عنوان “وثيقة إرادة الشعوب العربية”، فيما اعتُبر حينها نقلة نوعية في خطاب المؤسسة الأزهرية، ثم أعقب ذلك وثيقة “مستقبل مصر” في يونيو/ حزيران 2011، ثم وثيقة “منظومة الحريات الأساسية” في مطلع عام 2012. وبذلك استطاع الأزهر تلقّف الفراغ السياسي الذي أنتجته ثورة يناير، مدشّنًا من نفسه مرجعيةً للحركة الوطنية المصرية.
الأزهر وانقلاب الثالث من يوليو
لم يكن وجود شيخ الأزهر في مشهد بيان الثالث من يوليو مفاجئًا لكثيرين، ليس فقط لموقف الرجل المناوئ للثورات، ولا لكونه أبدى تحفّظًا على الصعود السياسي للإخوان، ولا لكون الرجل معبّرًا عن تقاليد الدولة المصرية العميقة التي رأت الوافد الجديد “محمد مرسي” غريبًا على روح الدولة وموروثها فيما يتعلق بالحكم والسياسة، ولا لأن أية مستبد بحاجة إلى كاهنٍ يُروّج له انقلابه ويضفي الشرعية عليه.
ليس لكل هذا وحسب، بل كان الملمح الأبرز من ضلوع الأزهر -مُمَثّلًا في إمامه الأكبر- تعبيرًا عن حالة “التوجس وتنازع النفوذ” الذي طالما لازم علاقة الإخوان بالأزهر الشريف طيلة عقود. فالإخوان المسلمون رغم إعلانهم أنهم حركة وسطية ومطالبتهم باستقلال الأزهر وإعادة الاعتبار إليه فإن ذلك لم يكن كافيًا لتبديد مخاوف الأزهر وشيخه اللذين رأيا في الإخوان حركة أتت لتنازعهما النفوذ مستعيدةً منهما “حصرية الخطاب الديني” الذي استأثرت به دومًا المؤسسة الدينية لاعتباراتٍ كثيرة.
ورغم الدبلوماسية التي شابت علاقة الرئيس “مرسي” بالأزهر، فإنّ ذلك لا ينفي وجود “تنافس خفي” بين الطرفين حُسم فيه الأمر بانتصار المؤسسة الدينية. على جانبٍ موازٍ، عمد “السيسي” إلى ضرورة وجود الأزهر -مُمَثّلًا في شيخه- في مشهد الانقلاب؛ لإظهار الأمر باعتباره ثورةً شعبيةً لا انقلابًا عسكريًّا.
ليس هذا وحسب، بل إن السيسي سعى إلى تأسيس أيديولوجية فكرية ودينية بديلة للإخوان يضطلع الأزهر بالدور الأكبر فيها عبر تصدير خطابٍ ديني يقوم على مداهنة الحاكم والبعد بالدين عن معاني المقاومة والتمرد إلى “المعنى الشعائري”؛ ما يُعدّ علمنةً للإسلام من الداخل.
لكن، يبدو أن شقاقًا بين الطرفين بدأ يلوح في الأفق.
فقضايا كتجديد الخطاب الديني وتكفير داعش والموقف من الشيعة، فضلًا عن البيان الأخير لهيئة كبار العلماء الرافض لتقنين “الطلاق الشفهي” على غير رغبةٍ من السيسي، تُنذر بأن ثمة شقاقًا بين السيسي والأزهر بدأت بوادره بهجومٍ عنيفٍ من أبواقٍ موالية للنظام الهدف منها -على ما يبدو- دفع شيخ الأزهر إلى الاستقالة؛ ليؤكد هذا حقيقة من نواميس السياسة أنه ما من شيخٍ داهنَ مُستبدًّا إلا وكان أول المكتوين بناره!
ثورة دينية
عشر مرات -على الأقل- وجه فيها السيسي دعوات إلى الأزهر الشريف لتصويب الخطاب الديني وتطويره من منطلق إيمانه بأن الأزهر الشريف هو المسؤول الأول عن تجديد الخطاب الديني، ليس في مصر فقط؛ بل وعلى مستوى العالم.
وتبرز أهميته بشكل أكبر في دوره الفاعل والحاسم في مواجهة الإرهاب والتصدي له، وهو ما دعاه في أكثر من مناسبة إلى مطالبة الأزهر بـ “ثورة دينية” لتجديد الفكر وتطوير الخطاب الديني بما يتناسب مع العصر الحالي؛ سعيًا إلى تغيير المفاهيم الخاطئة.
وردد في إحدى المناسبات أنه “ليس معقولًا أن يكون الفكر الذي نقدسه على مدار المئات من السنين يدفع الأمة بكاملها إلى القلق والخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها”. وطالب أكثر من مرة بأن يتصدى لهذه الأمور “أساتذة مستنيرون”، مؤكدًا أنه آن الأوان لتجديد الخطاب الديني الذي ظل رهينة تراث محدود بمعطيات الماضي وأبعاده.
الطلاق الشفهي.. نقطة تحول
بيد أن النقد الصريح الذي وجهه السيسي إلى شيخ الأزهر هذه المرة كان بسبب استعراض الرئيس معدلات الطلاق المتزايدة في مصر، والتي فاقت كل التوقعات بحسب إحصاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ووجد السيسي في هذا الأمر تهديدًا للأسر والعائلات وتفتيتًا لتماسكها يتطلب التدخل وتغيير القوانين لتجريم “الطلاق الشفهي”، واشتراط أن يكون “الطلاق مكتوبًا”؛ كفرصة يراجع فيها الزوجان موقفهما قبل الشروع في الطلاق الفعلي.
ويبدو أن فتح هذا الملف كان نقطة تحول في العلاقة بين السيسي والأزهر؛ حيث أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر بيانًا عارضت فيه طلب السيسي وأسقطته من الناحية الشرعية.
أحد ورثة مبارك
من ناحيته، يرى الشيخ عبدالعزيز رجب -من علماء الأزهر- أن الطيب “أحد ورثة” نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ممن يسببون قلقًا للسيسي؛ كونه كان عضوًا بلجنة سياسات الحزب الوطني.
كما أن السيسي -والحديث لرجب- يرى أن ولاء الطيب لا يزال لدولة مبارك العميقة، وأنه يراعي حساباته الخاصة ولن يجازف بحرق كل أوراقه لأجله.
ويتابع: “هدف الضغط على أحمد الطيب هو إجباره على الانصياع الكامل لكل طلبات السيسي، التي يرفضها بعض المقربين منه ممن لا يزال فيهم رمق للخير؛ وبالتالي فالهدف إجباره على تغيير مواقفه غير المتجانسة مع توجهات رئيس الجمهورية أو دفعه إلى الاستقالة”.
ذهب الشيخ عبدالعزيز إلى أن ثقل الطيب، خاصة لدى الطرق الصوفية وعائلات الصعيد، يجعل التخلص منه أمرًا عسيرًا، ويتيح له أن يكون ندًا لقرارات يؤيدها السيسي ولو من وراء ستار؛ مثل الموقف من الخطبة المكتوبة، مشيرًا إلى أنه في حال أُجبر على الاستقالة فالبديل إما علي جمعة أو أسامة العبد.
موقف الدولة
في المقابل، يرى رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي أن “هجوم بعض الإعلاميين على شيخ الأزهر لا يعبر عن موقف الدولة المصرية، وأنه من قبيل التطوع المبني على خيالات بأن ذلك يحقق مراد السيسي؛ وهو الأمر الذي لا حقيقة له”.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن شيخ الأزهر يحظى بمكانة مرموقة ومقام سام، والدستور منح منصبه حصانة كاملة؛ فهو غير قابل للعزل، كما أنه رجل صلب صاحب مواقف شجاعة في حماية الأزهر ومكانته، وواجهته مواقف صعبة ومشاكل كثيرة خرج منها منتصرًا بالإصرار على عدم التنازل، على حد تعبير “الشهابي”.
وشدد على أن السيسي والدولة المصرية يعرفان هذه المكانة المحفوظة للطيب في نفوس المسلمين بالعالم، التي لا يُتصور معها أن يتم السعي إلى إقصائه، “ومن ثم؛ فما يقوم به بعض الإعلاميين من مطالبة الطيب بالاستقالة لا يمكن وصفه إلا بالغباء”. وتابع أن دعوة السيسي لأحمد الطيب واستقباله له مؤخرًا خير دليل على وعي الدولة المصرية ومؤسساتها.