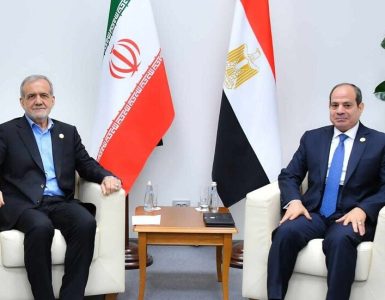الخائفون من التغيير تدفعهم مبررات متعددة، بعضها مرتبط بعاطفة الأبوة ونزعة الوصاية، وبعضها مرتبط بنمط العلاقة الفريد بين أعضاء الإخوان وبين تنظيمهم، وبعضها مرتبط بهوى النفس وحب الرئاسة والنفوذ الإداري والمالي. تنتمي العوامل الأولى لحقلي الاجتماع والسياسية، أما الأخير فعلمه عند الله، وحده سبحانه يعلم المفسد من المصلح. لذا لن نتطرق إليه في حديثنا حتى لا نتورط في «أكذب الحديث»!
عاطفة الأبوة ونزعة الوصاية
ليس من الخفي أن جماعة الإخوان المسلمين على مدار تاريخها لم تتسم بقدر كاف من المؤسسية والشفافية؛ بالتأكيد هي جماعة «منظمة» بل شديدة التنظيم، لكن آليات عملها الداخلي لم تتسم يوما بـ«المؤسسية» حتى في عهد الإمام المؤسس «حسن البنا»، بحسب مذكراته هو شخصيا ومذكرات معاصريه التي تكشف بوضوح أن قرارت حاسمة وسياسات عامة للجماعة كان يقررها «البنا» منفردا دون أن تعارضه قيادات الجماعة ومؤسساتها العليا إلا فيما ندر.
كان «البنا» شخصا ملهما، وقائدا فذا، اهتم بتأسيس تنظيم هرمي مركزي، وبناء رجال أكفاء مثابرين، لكنّه لم يهتم بنفس الدرجة بإرساء ثقافة مؤسسية شورية حازمة، فكانت النتجية أن دخلت الجماعة في دوامة عقب استشهاده، وتنازعت قياداتها على خلافته، إلى أن حسم الخلاف بطريقة لا علاقة لها بلوائح الجماعة المكتوبة، وهو ما أسس لممارسة متكررة من “الاستثناء”، الذي بحكم تعريفه لا يحمل إجابة محددة عن سؤال ظل رئيسيا داخل الجماعة: متى نلجأ للاستثناء؟ ومتى نتقيد باللوائح؟ دائما كانت الإجابة تقررها – فقط – دائرة ضيقة من قيادة الجماعة العليا.
مع التأسيس الثاني للجماعة – من أواسط السبعينيات وحتى حوالي عام 1987 – أصبح التنظيم شديد المركزية والإحكام؛ لم تعد الجماعة “جمعية” مفتوحة العضوية كحال جمعية «حسن البنا»، بل تنظيم مغلق بُني أساسا على ثقافة السرية التي فرضت عليه بحكم الظرف السياسي العام وموقف الدولة الرافض لعودة الجماعة كمؤسسة طبيعية. السرية وموجة الاستهداف الأمني التي انطلقت في التسعينيات، بالإضافة إلى ثقافة داخلية تكرس «فقه الاستثناء»: المحنة/الابتلاء/الثقة/البعد عن طلب المسؤولية ..الخ كلها أجواء ومفردات ساهمت في إدارة التنظيم أموره الداخلية دون التفاف حقيقي لأهمية تطوير آليات المأسسة الإدارية بما يواكب حجم التنظيم الهائل.
ليس من المستغرب إذا أن يظل بعض أعضاء مكتب الإرشاد منذ الثمانينيات والتسعينيات داخل المكتب، وبصورة عامة هيمنت القيادات المتقدمة في العمر على قيادة الجماعة وسط مناخ يحترم الكبير، ويحفظ لهم فضلهم وسبقهم. لكن هذه العاطفة النبيلة ولدت لدى بعض القيادات عاطفة مقابلة، تراوحت بين الأبوة التي تستبطن دائما المعرفة والحكمة، أوالوصاية التي تستبطن احتكار التوجيه وأحادية الرأي وفقدان الثقة في أي بديل حديث السن أو مستجد العضوية.
الخائفون من المستقبل لا يثقون في قدرة غيرهم على تحديد مصلحة الجماعة، ولا يمكنهم ببساطة أن يسلموا مفاتيح إدارتها لأي وافد. لا يمكنهم المغامرة، ولا يستسلمون لأي نزعة تطويرية، ويرقبون بحذر أي محاولة للتجديد.
الخائفون من المستقبل مثل الأب الذي يصر على اختيار كل شيء لابنه اليافع، لكنّ الأحوال تتغير، والزمن يتطور، وإن لم يستسلم الأب ويكتفي بالنصح والتوجيه – عند الحاجة – سيفجعه ولده بتحدي وصايته.
الجماعة الأولية
من اللافت أن كتابات الشهيد «سيد قطب» لم تقدم إشادة واضحة لـ«حسن البنا» وجماعته إلا تجاه ملمح واحد: التنظيم. لم يتحدث «قطب» كثيرا عن منهج الجماعة الشامل ولا عن سرعة انتشارها وتمددها، لكنّ ما فتنه في مسيرة «البنا» هي عبقريته التنظيمية، وتنظيمه العبقري.
كان «قطب» مسكونا بمشروعه الذي سيصبح فيما بعد النموذج الملهم للكثير من الإسلاميين في العالم: الطليعة الإسلامية التي تقود البعث الإسلامي. هنا كانت عبقرية «البنا» التنظيمية هي ما يحتاجه «قطب» كي يوجه إليها مشروعه الفكري. بالتأكيد لو امتد العمر بالشهيد «سيد قطب» حتى التأسيس الثاني للجماعة لكان أشد إعجابا بالبناء التنظيمي المحكم، ليس فقط لعنقوديته وترابطه بدءا من القيادة العليا إلى أصغر الوحدات التنظيمية، وهو ما بدأ مع «البنا» بالفعل في سنواته الأخيرة، لكن – واستجابة لظروف السرية وانغلاق المجتمع المصري عموما مقارنة بالحياة الليبرالية قبل انقلاب يوليو1952م – أضيف إليه هيمنة شاملة على حياة أفراده، فيما يعتبر نموذجا فريدا لما يطلق عليه ”التنظيمات الأولية“.
جماعة الإخوان ليست حزبا سياسيا، وليست مؤسسة اجتماعية، كما أنها بالتأكيد ليست مجرد جمعية دينية تعنى بالتربية والتهذيب الأخلاقي. هي محصلة فريدة من كل هذا وزيادة، وهو ما أعطاها هامشا واسعا لاستقطاب الأعضاء وتلبية ميولهم، سواء كانت سياسية أو تنموية أو دعوية …الخ لذا مهما أخفقت الجماعة في أدائها السياسي، نادرا ما سبب لها هذا أزمة داخلية كون مبررات بقائها متنوعة، وميول أفرادها لا يمكن حصرها في المواقف أو الممارسة السياسية.
“الجماعة الأولية” تعمل كوسيط مباشر بين الفرد وبين مؤسسات المجتمع. كالعائلة مثلا في المجتمعات التقليدية. في الإخوان لا يمكنك ببساطة أن تعلن ترشحك لعضوية نقابتك المهنية دون أن يكون ذلك قرار الجماعة، كما أنك لن تشارك ابتداءا إلا إذا أقرت الجماعة المشاركة. وهو ما ينطبق بالتأكيد على عضوية الأحزاب السياسية وتبني مواقف سياسية معينة. توفر الجماعة شبكة واسعة من المؤسسات المدنية (مدارس، ومستشفيات، وجمعيات أهلية ..الخ)، صحيح أنها تخدم عموم المجتمع، لكنها تمثل أيضا مجتمعا للأعضاء.
هذا القدر الهائل من الهيمنة والحضور للتنظيم في حياة الفرد، ساهم في وجود من يطلق البعض عليهم “شعب الإخوان”، وهم آلاف من الأعضاء لايمارسون أدورا تنظيمية معينة لكنهم متمسكون بعضويتهم، ويحافظون على صلاتهم الاجتماعية والإنسانية بالتنظيم الذي بات يمثل لهم مجتمعا مصغرا أكثر قبولا من المجتمع العام الذي تسوده ثقافة أو قيم لا يمكنهم القبول بها.
هذا الارتباط غير العادي بالتنظيم، يجعل عملية الانفصال عنه كالجراحة التي تتم بدون بنج! ليس من السهل على الفرد اتخاذ قرار من هذا النوع، كما أنه لا يتقبل ببساطة قرارا يحرمه مجتمعه، من هنا يصاحب هذه العملية آلاما للطرفين، ولا يمكن أن تتم بهدوء.
من ثم يكون الحفاظ على التنظيم والدفاع عنه رد فعل بديهي لأفراده، ضد أي تهديد، وهو ما يعوق دائما أي اتجاهات تغييرية جذرية. خاصة إذا استطاعت قيادة الجماعة تصوير دعاوى التغيير كتهديد يمس بقاء وتماسك التنظيم. ليس من المستغرب عند تعرض التنظيم لحرب خارجية من الدولة أن يسهل تجاهل أي صوت ينادي بالتغيير أو الإصلاح أو التقويم، وهي الحالة الممتدة منذ فترة تلتهم غالبية عمر الجماعة الحالية.
تصاعد الأزمة مؤخرا، يعني ببساطة أن هذه المعادلة اهتزت بعنف. يبدو أن مفاجأة الثورة التي غيرت وضع الجماعة وحررتها لعدة أشهر من قبضة الاستناء، ثم صدمة الانقلاب ورابعة وما بعد رابعة، وعجز الجماعة عن إدارة المواجهة مع سلطة الانقلاب العسكري بأدوات ناجعة، فضلا عن تقديم مبررات مقنعة لعموم الإخوان بعد الثمن الباهظ الذي تتكبده الجماعة وأفرادها، يبدو أن كل هذا يتطلب ما هو أكثر من خطابات التسكين وأدبيات المحنة.
لم تستوعب قيادة الجماعة، من بقي منها للدقة، حجم التغير الهائل الذي حدث منذ الثورة وحتى رابعة. ربما لم تشعر بحجم التغير لأنها هي نفسها لم تتغير، ولم تبد أي مؤشر على قدرتها أو رغبتها في إحداث أي تطوير، أو القيام بأي مراجعة؛ بل أعنلت صراحة أن الجميع «بذل وسعه»، وأن الوقت عير مناسب للمحاسبة. وهو ما يعني ضمنا استمرار كافة المقدمات التي أفضت إلى النتائج الحالية: فطالما لا توجد محاسبة ستظل آليات الإدارة واتخاذ القرار كماه هي، وستظل القيادات السابقة تلعب الدور الرئيسي في توجيه دفة المشهد. هل من المتوقع أن تقود نفس المقدمات إلى نتيجة مختلفة؟!
من المفهوم إذا، أن يعلو صوت النقد على صوت المعركة هذه المرة، وأن يكون الإصلاح والتغيير الداخلي هو الخطوة المنطقية في نظر البعض داخل الجماعة لإحداث أي تغيير في المشهد الخارجي. وكلما أظهرت القيادة تمسكا بمواقفها ومواقعها، كلما زادت حدة الأصوات التي فوجئت أن أبواب التغيير – رغم الإخفاق الكبير – لازات مغلقة!
يكفي اللبيب إشارة مكتومة :::: وسواه يُدعى بالنداء العالي
الأسوأ في المشهد، أن قيادة الجماعة لم تبذل الكثير لاحتواء الموقف هذه المرة، وقررت السير في طريق تظن أنه سيحسم الجدل، وينهي الأزمة، بينما جميع المراقبين يرونه يفجر الجماعة من داخلها. وبينما تؤكد أن اللحظة غير مناسبة للانتخابات الداخلية أو إجراء مراجعات ومحاسبات، إذا بنفس اللحظة تسمح بتحقيقات وقرارات إدارية بحق العشرات.
ثمة من يحتاج إلى معرفة أن جماعة الإخوان المسلمين ليست قدرا حتميا! وأن أمما بأكلملها أصبحت أحاديث، وأن السنن لا تبالي ولا تحابي، وأن المقوم الرئيسي لبقاء الإخوان طوال هذه السنوات ليس التنظيم المحكم وإنما الفراغ الحضاري الذي عملت الجماعة على ملئه واستمدت قيمتها من فاعليتها في أداء هذه المهمة، وأن استمرار البقاء منوط بالاستجابة لمتطلبات اللحطة التاريخية الجديدة التي تمر بها الأمة، وإلا فلا قيمة لأي جماعة إذا فقدت فاعليتها الحضارية والتاريخية.
أوقات الفتن هي مواسم الشيطان، وأعداء الجماعة من خارجها لم يضعوا أسلحتهم بعد، وما يحتاجه الإخوان حاليا ليس قرارت إدارية، وليس حربا إعلامية متبادلة. هذه هي اللحظة التي يظهر فيها العقلاء، والمتجردون من هوى النفس وحب السلطة … وقليل ما هم.
* عمار فايد، باحث مصري وعضو بجماعة الإخوان المسلمين