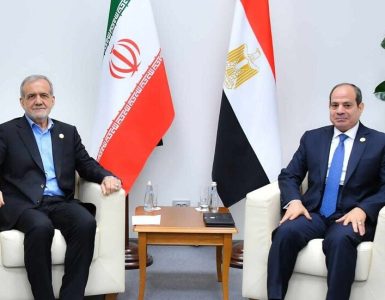أثار الهجوم على صحافيي شارلي إيبدو الفرنسية الجدل من جديد حول عدد من القضايا التي تلعب دوراً رئيسياً في تشكل العلاقة المشتبكة بين المسلمين وأوروبا، سواء في الدول الأوروبية ذاتها أو على مستوى العلاقات بين الدول.
أول هذه القضايا وأكثرها تعقيداً هي تلك المتعلقة بمسألة الحرية، التي شغلت الثقافة الأوروبية منذ عصر التنوير في القرن الثامن عشر، وردود لايبنز وأسبينوزا على ديكارت. ما توحي به رسوم شارلي إيبدو، وتصميم الصحيفة والمدافعين عنها على صواب الموقف من نشر الرسوم، ليس فقط إعادة التوكيد على النزعة الراديكالية، المناهضة للدين، للعلمانية الفرنسية، ولكن أيضاً أن هناك من يرى بأن حرية الرأي مطلقة ولا حدود لها. والحقيقة، أن فكرة الحرية، سواء بمعنى حرية المعتقد، الضمير، أو الرأي، ولدت أصلاً من المواجهة بين أوروبا الحديثة وميراثها الديني، وعبر عنها في الخطاب الأكثر وضوحاً خلال عصر التنوير، الذي ولد هو الآخر من ركام قرنين كاملين من الصراعات الدينية ـ السياسية. وربما كان التعديل الأول للدستور الأمريكي، في ثمانينات القرن الثامن عشر، الذي أقر التخلي عن المأسسة الدينية، بمعنى تحرير الدولة من أي ارتباط خاص بأي من الكنائس المسيحية، الخطوة الأسبق نحو تبني الدولة لمبدأ الحرية. بيد أن الواقع أن الدول الأوروبية الغربية، مهد الصراعات الدينية وعصر التنوير، معاً، تعاملت دائماً مع الدين والحرية بقدر كبير من البراغماتية. وحتى الارتباط بين الدولة ومؤسسة الكنيسة لم يتم التخلي عنه بصورة شاملة، ولا بصورة سريعة.
أحتاج الأمر في أمريكا حتى العقد الرابع من القرن التاسع عشر لتفك آخر الولايات الثلاث عشرة، التي شكلت الولايات المتحدة آنذاك، ارتباطها مع الكنيسة. وفي بريطانيا، لم تزل الملكة، ممثلة برئيس حكومتها، ترأس الكنيسة الإنجليكانية، بالرغم من أن هذه العلاقة أصبحت أكثر رمزية منها إلى الفعلية؛ ولم يرفع المنع عن إقامة كنائس كاثوليكية جديدة في إنكلترا حتى الستينات من القرن العشرين.
وقد تجلت براغماتية الدولة بصورة أكثر وضوحاً في التعامل مع مبدأ الحرية. في الولايات المتحدة، مثلاً، حيث ترتكز حرية التعبير والمعتقد لجذور إلى جذور أكثر رسوخاً من معظم الليبراليات الأوروبية، تعرض الشيوعيون للمطاردة في الخمسينات بصورة منهجية، وتحت إشراف لجنة برلمانية.
وحتى وقت قريب، في 2007، لم تتردد جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا من القبض على الطالب ماكس كارسون وإرساله للسجن والمحاكمة، ومن ثم طرده من الحرم الجامعي، بعد أن أعرب في مناقشة بفصل دراسي عن تعاطفه مع الطالب الغاضب الذي أطلق النار على زملائه في الجامعة، وقتل أكثر من ثلاثين منهم. وقد أسست قوانين مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة وبريطانيا لقيود قاسية على حرية التعبير منذ 2001، أدت إلى محاكمة وتجريم وسجن أكثر من شخص في بريطانيا في السنوات القليلة الماضية. وربما تعتبر مسألة إنكار الهولوكوست، أو المحرقة التي أقامها النازيون لليهود، الأكثر شهرة، بعد أن أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون في عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا نفسها.
القضية الثانية التي أثارتها حادثة شارلي إيبدو، كون من قاموا بالهجوم على الصحيفة مسلمان من أصول جزائرية، تتصل بمستقبل الجاليات المسلمة في الدول الأوروبية، سيما الأوروبية الغربية، التي لم تعرف وجود مسلمين في مجتمعاتها حتى قبل أقل من قرن من الزمان. ولد الأخوان المهاجمان في فرنسا وعاشا وتعلما فيها، وهما على الأرجح من أبناء الجيل الثاني أو الثالث من مسلمي فرنسا؛ ما أعاد الجدل، في فرنسا، كما في دول القارة الغربية، على السواء، حول مسألة الإندماج والتعددية الثقافية في المجتمعات الأوروبية.
والحقيقة، أن الصورة المتعلقة بمستقبل الجاليات المسلمة في أوروبا الغربية لا تدعو إلى التفاؤل. ولدت فكرة التعددية في أوروبا (مرتكزة إلى فكرة التسامح في البداية)، كما الحرية وحيادية الدولة تجاه الدين، من رحم الحروب الدينية، التي أطلقها الإنشقاق البروتستانتي في القرنين السادس والسابع عشر. ولكن التعددية الأوروبية في أصلها لم تكن تعني أكثر من التعددية المسيحية.
ولفترة طويلة، ظل العداء لليهود، مثلاً، واسع الانتشار في المجتمعات الليبرالية الأوروبية، بما في ذلك فرنسا. أما في ألمانيا، فقد انتهى مصير اليهود إلى المحرقة في منتصف القرن العشرين، كما هو معروف، وبعد أن كان مضى على الوجود اليهودي في المجتمع الألماني عدة مئات من السنين. وحتى بعد المحرقة النازية، لم تنته مظاهر العداء لليهود كلية في المجتمعات الأوروبية الغربية. وليس ثمة شك أن الحماس البريطاني (وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، بعد ذلك) للمشروع الصهيوني في فلسطين حمل في أحد وجوهه رغبة أوروبية ضمنية للتخلص من يهود القارة.
تم في النهاية، بالطبع، القبول بما تبقى من الوجود اليهودي في المجتمعات الأوروبية، سيما بعد أن لعبت قوى الاندماج والسياسة والمصالح فعلها. ولكن الإسلام مسألة أخرى بالتأكيد. ثمة قطاع من مسلمي أوروبا سينتهي إلى التخلي الكامل عن هويته السابقة والإندماج الكلي في المجتمعات الأوروبية، بالرغم من أن من الصعب تقدير حجم هذا القطاع. ولكن الواضح أن القطاع الأكبر لن يقبل التخلي عن عناصر هويته كلية، ولن يقبل بالتالي بالإندماج الكامل.
والمشكلة هنا ليست في المدى الذي يمكن أن يتسع له مفهوم التعددية، بل في العودة الحثيثة للنزعات القومية إلى دول القارة، النزعات التي لم تستطع وعود الوحدة الأوروبية كبحها. ما لا شك فيه أن أوروبا الغربية اليوم أكثر قومية مما كانت قبل عشرين عاماً؛ وبالرغم من أن اللغة إحدى العناصر الحيوية للهوية القومية، فإن اعتناق اللغة الإنكليزية أو الفرنسية أو الإيطالية أو الألمانية لا يكفي لتأمين موقع للمسلمين في القوميات الأوروبية الغربية.
المسلمون ليسوا جزءاً من الموروث الثقافي لهذه الدول، ولا من بنيتها العرقية المتصورة، ولا من موروثها التاريخي؛ وهم بالتأكيد ليسوا مسيحيين. وهذه العناصر معاً هي ما يشكل الهويات القومية الأوروبية الصاعدة.
أما المسألة الثالثة فتتعلق بمناخ الفجيعة والصدمة الذي سيطر على فرنسا وعموم القارة الأوروبية إثر الهجوم على شارلي إيبدو. لم يتجاوز عدد ضحايا الهجوم 12 شخصاً؛ وبالرغم من أن موت إنسان واحد هو خسارة كبرى في كل الأحوال، فإن السوريين والعراقيين يموتون يومياً بالعشرات بدون أن يجزع العالم لهم. كما لم يثبت حتى الآن، بغض النظر عن إعلان قاعدة الجزيرة العربية الركيك، أن مرتكبي الهجوم ينتمون لتنظيم أكبر، يمكن أن يهدد أمن فرنسا واستقرارها لهذه الفترة الزمنية أو تلك.
والأرجح أن هذين الشابين ليسا أكثر من نبت محلي، غاضب، يجب أن يوضعا في سياق العلاقة المرضية بين فرنسا ومواطنيها المسلمين من أبناء المستعمرات السابقة. ما أوحى به رد الفعل الفرنسي، والأوروبي بصورة عامة، أن فرنسا كلها باتت مهددة، وأن الهجوم على شارلي إيبدو لا يقل عن الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية.
في معمل طبي، يمكن بسهولة القيام بتطهير كامل لإحدى الأدوات أو الأشياء، بمجرد وضعها في جهاز تعقيم لفترة زمنية محددة، في درجة حرارة عالية. ولكن من المستحيل تعقيم الحياة، وتطهيرها من الموت والألم والحادث المأساوي، سيما في دولة تفترض لنفسها دوراً نشطاً في الساحة الدولية، لا يخلو دائماً من الجدل. ونصيب فرنسا من الموت والألم والمأساة يوم 7 يناير/ كانون ثاني كان صغيراً نسبياً، إن قورن بحجم الموت والألم والمأساة الذي يثقل حياة شعوب أخرى. ولكن رد الفعل الفرنسي كان من الصدمة والفجيعة ما يشير إلى أن شعوب القارة الأوروبية العجوز لم تعد تستطيع تحمل أعباء الحياة الطبيعية، مهما كان حجم هذه الأعباء.